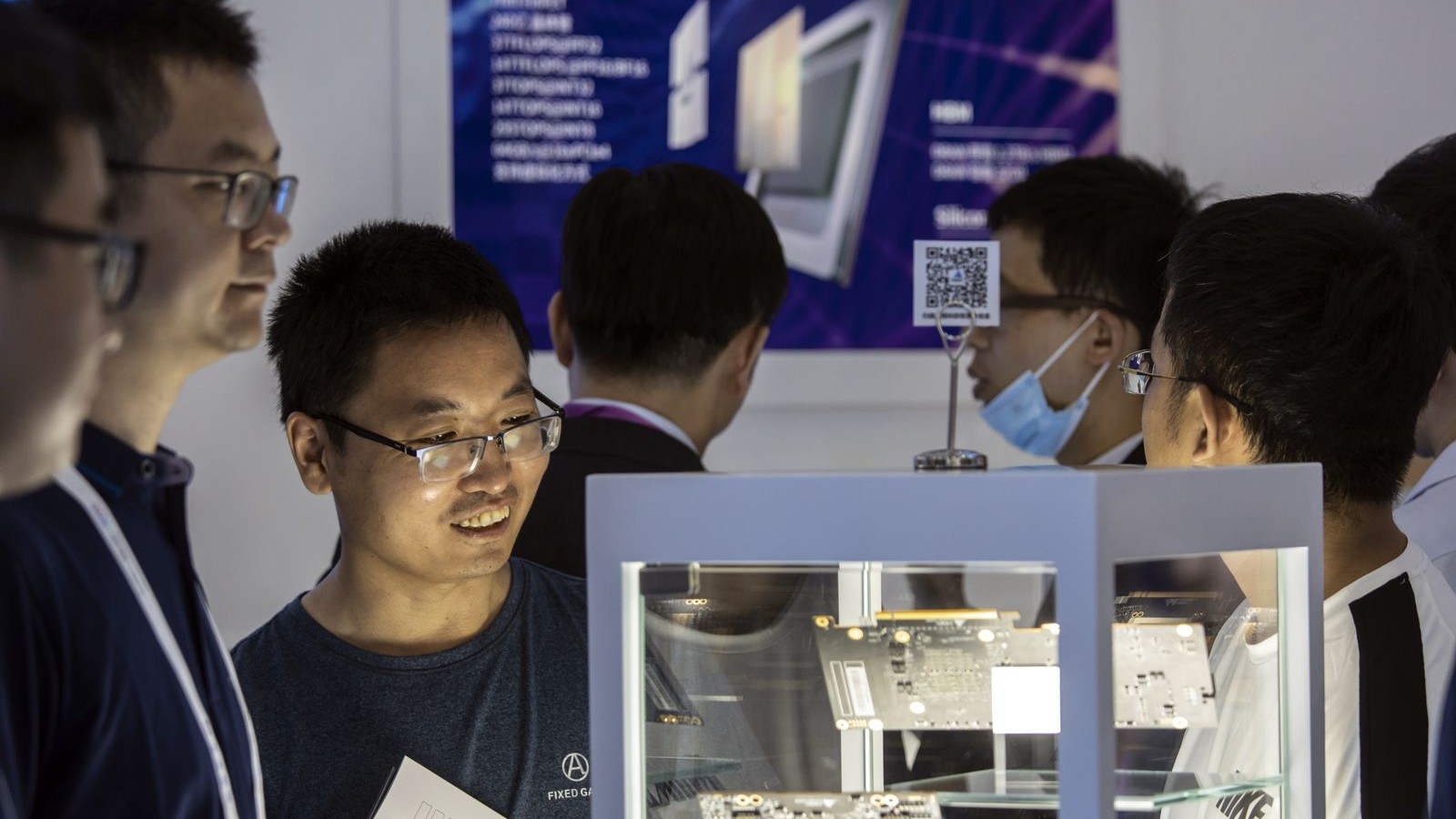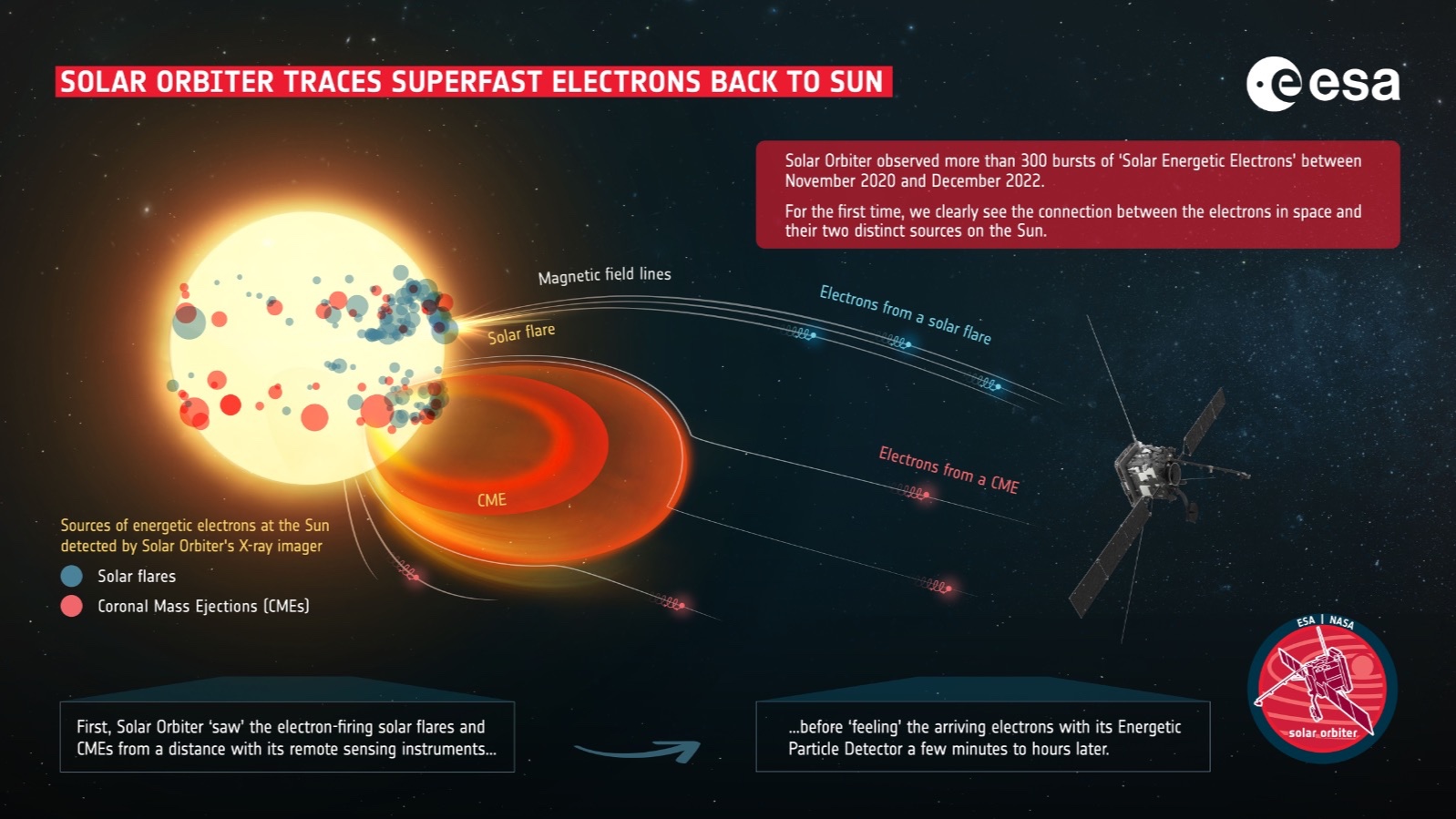بعد التشويش على طائرة أورسولا.. هل يستطيع العالم الاستغناء عن نظام GPS؟
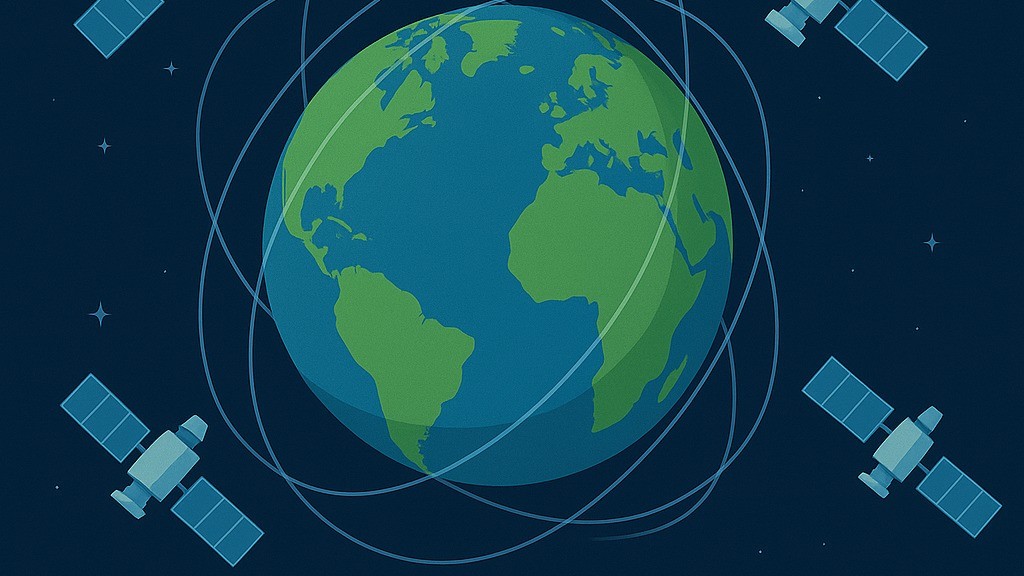
على ارتفاع آلاف الأمتار فوق بلغاريا، فقدت الطائرة التي كانت تستقلها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوصلة الملاحة الجوية، وسلكت طريقًا مجهولًا، ودارت لمدة ساعة كاملة، دون أن تعرف طريقة لتحديد موقعها بدقة، وانتهت الأزمة باللجوء إلى الخرائط الورقية ومهارة مراقبي الحركة الجوية، حتى الهبوط بأمان في مطار بلوفديف.
هذا الموقف العصيب كان وراءه ضباب أعاق عمل الطيارين، لكن الضباب لم يكن في الطقس، وإنما إلكترونياً، إذ أكد خبراء، والسلطات المختصة في بلغاريا، أن نظام الملاحة الجغرافية GPS تعرّض لتشويش متعمّد،
وأشارت أصابع الاتهام إلى روسيا في وقوفها خلف ما أصبح يُعرف بـ”حرب هجينة” إلكترونية تهزّ أجواء أوروبا الشرقية، وتضرب ثقة الأمم في إشارات تُبث من الفضاء.
ما هو نظام تحديد المواقع العالمي GPS؟
نظام تحديد المواقع العالمي GPS، هو شبكة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، وظيفتها الأساسية تزويد أي جهاز مستقبل على سطح الأرض، أو في الجو أو البحر بمعلومة دقيقة عن المكان والزمان.
هذا النظام صُمم أولاً لأغراض عسكرية أميركية في السبعينيات، ثم أتيح للاستخدامات المدنية لاحقًا، وأصبح جزءًا من الحياة اليومية.
ويعتمد هذا النظام في عمله على فكرة بسيطة، لكنها معقدة في التنفيذ، ولتوضيح ذلك تخيّل أنك تقف في مدينة غريبة، وتحاول أن تعرف أين أنت بالضبط، فإذا سألت شخصًا واحدًا، وقال لك “أنت على بعد 5 كيلومترات مني”، فلن تعرف موقعك بدقة. لكن إذا أخبرك شخصان أو ثلاثة بالمسافات بينكم، تستطيع تقريبًا أن تحدد مكانك بالتقاطع. هذه هي فكرة التثليث (Triangulation)، أو بالأدق التثليث الكروي (Trilateration).
وترسل الأقمار الصناعية في نظام GPS (عددها 31 قمرًا نشطًا) إشارات مشفرة تحتوي على الوقت الدقيق جدًا الذي أُرسلت فيه الإشارة، إضافة إلى موقع القمر في المدار، ويستقبل الهاتف أو أي جهاز ذكي هذه الإشارات من 4 أقمار على الأقل، ويقارن زمن وصولها، وبما أن الإشارة تصل بسرعة الضوء، فإن الفرق في الزمن يخبر الجهاز كم يبعد عن كل قمر، ومن خلال حسابات رياضية معقدة، يحدد الموقع بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات في بعض الأجهزة المتطورة.
ولكي يعمل النظام بهذه الدقة، يحتاج إلى ساعات ذرية فائقة الانضباط داخل الأقمار الصناعية، وإلى شبكة محطات أرضية تراقب الأقمار باستمرار لتصحيح مواقعها وأوقاتها، وأي خطأ صغير في التوقيت (حتى نانوثانية واحدة) يمكن أن ينتج عنه خطأ في تحديد الموقع ربما يصل إلى مئات الأمتار.
وحالياً لا يحدد نظام GPS الموقع فقط، بل يوفر ما يُعرف بخدمة التوقيت والمزامنة (PNT: Positioning, Navigation, Timing)، وهي خدمة أساسية لعمل شبكات الاتصالات، والبنوك، والبورصات، وحتى محطات الطاقة، إذ تحتاج كلها إلى توقيت متزامن ودقيق للغاية.
محاولات الاستقلال عن النظام الأميركي
محاولات الدول للاستقلال عن نظام الملاحة الأميركي GPS لم تأت من فراغ، بل نتيجة مجموعة متشابكة من الأسباب الأمنية والسياسية والتكنولوجية والاقتصادية.
هذه الأسباب تمثل في جوهرها مسألة سيادة وطنية، لكن لكل دولة حساباتها الخاصة التي تدفعها للاستثمار بمليارات الدولارات في مشروعات بديلة.
ويعتبر الأمن القومي السبب الرئيسي لسعي الدول إلى تطوير بدائل لنظام GPS، الذي تملكه وتشغَّله وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وهو قادر على تقديم مستويات مختلفة من الخدمة، بل وحرمان جهات معينة من الإشارة عند الضرورة.
هذا الاحتمال يجعل الدول الأخرى عرضة لضغط جيوسياسي، خاصة في أوقات الأزمات أو النزاعات، وخرجت بعض الدول، مثل الهند التي واجهت محدودية في استخدام GPS خلال حرب كارجيل أواخر التسعينيات، من التجربة بقناعة راسخة أن الاعتماد على نظام أجنبي في مسائل دفاعية خطيرة يشكل تهديدًا استراتيجيًا.
السبب الثاني هو أخطار التشويش والتزوير، وإشارات GPS ضعيفة بطبيعتها؛ لأنها تُبث من أقمار تبعد نحو 20 ألف كيلومتر عن الأرض، وهو ما يجعلها عرضة للتداخل المتعمد (jamming) أو التلاعب (spoofing)، وهي تقنيات أثبتت فعاليتها في الحروب الحديثة، مثلما حدث في الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث جرى تسجيل محاولات متكررة لتعطيل إشارات الملاحة، ما يجعل امتلاك منظومة وطنية، أو على الأقل إقليمية، يوفر طبقة إضافية من الحماية، ويجعل عملية التشويش أكثر تعقيدًا.
وإلى جانب الأمن، هناك دافع اقتصادي وتجاري لا يقل أهمية، فتقنيات الملاحة الدقيقة أصبحت ركيزة لاقتصادات القرن الحادي والعشرين، بدءًا من تشغيل شبكات الاتصالات، مرورًا بإدارة حركة الموانئ والمطارات، وصولًا إلى قيادة السيارات ذاتية التشغيل والطائرات المسيّرة.
والدول التي تملك منظومتها الخاصة تضمن استقلالية في هذه القطاعات، وتفتح لنفسها فرصًا لتصدير التكنولوجيا وتعزيز نفوذها عبر دمج أنظمتها في الأسواق العالمية.
وهناك أيضًا بُعد تقني وبحثي، إذ ترى الدول أن الاعتماد على GPS يضعف من قدراتها الابتكارية، في حين أن بناء منظومة مستقلة يفتح آفاقًا للتطور في مجالات متعددة، مثل تصنيع الأقمار الصناعية، وتطوير محطات المراقبة، وتطبيقات الملاحة المتقدمة، ولهذا السبب هناك مشروعات مثل Galileo الأوروبي لا تُقدَّم فقط كخدمة ملاحة، بل أيضًا كمنصة علمية وتقنية تعزز مكانة أوروبا في الفضاء والابتكار.
وأخيرًا، يظهر بوضوح البعد الرمزي والسيادي، فامتلاك منظومة ملاحة خاصة يعني بالنسبة لكثير من الدول أنها لاعب من “الصف الأول” في التكنولوجيا العالمية، وهو إعلان صريح بأن الدولة قادرة على التحكم في إحدى أهم البنى التحتية الرقمية للحياة الحديثة، ما يرفع من وزنها على الساحة الدولية.
بدائل نظام GPS
منذ إرساء نظام الملاحة الأميركي GPS في أواخر القرن العشرين، أصبحت إشاراته العمود الفقري لتطبيقات الملاحة الدقيقة في كل مكان، من الطائرات إلى الهواتف، لكن الاعتماد الكامل على منظومة يتحكم فيها طرف واحد شكّل مشكلة تتجاوز التقنية إلى ما هو أمني وجيوسياسي، وبدأت دول متعددة تستعيد زمام المبادرة.
وشرعت الصين في تطوير منظومة الملاحة BeiDou كمشروع إقليمي صغير، لتتحول تدريجيًا إلى شبكة عالمية مغلقة، تحمل على عاتقها هدف تحجيم الهيمنة الأميركية التقنية. عبر استثمارات ضخمة داخل البلاد وخارجها، ضمن مشروعات مثل “الحزام والطريق”.
وأصبحت BeiDou ليست مجرد أداة توجيه، بل بوابة نفوذ تجاري وسيادي.
روسيا، التي سبق أن عانت انهيار منظومتها الفضائية، أعادت إنتاج نظامها الفضائي GLONASS ليصبح منافسًا فعليًا لـ GPS، يغطي الكرة الأرضية بثبات نسبة دقة تتراوح بين 2.8 و7.4 أمتار.
وأسهم التحالف الروسي – الصيني في تبادل استضافة محطات الرصد، ما زوّد النظامين بميزة إضافية في دقة التحديد والمقاومة لاضطراب الإشارات.
ولم يكن الاتحاد الأوروبي بمعزل عن هذا التوجه، إذ أطلق مشروع Galileo ليكون بديلاً مستقلاً لإحداث توازن بين القوى، ويُقدّم النظام دقة تبلغ أقل من متر عند استعمال الإرساليات المصححة، وهو يضع أوروبا بعيدًا عن تبعية GPS أو GLONASS، رغم تأخر تنفيذ بعض مراحله.
كذلك الهند، التي واجهت قطعًا في بيانات GPS في حرب كارجيل عام 1999، تطوّر بهدوء منظومتها الإقليمية NavIC، التي تغطي شبه القارة الهندية والمناطق التابعة حتى 1500 كيلومتر، واعتبر إطلاق القمر الجديد “NVS-02” مطلع عام 2025 خطوة احترافية لتعزيز استقلالية الهند في الملاحة.
وفي آسيا، لا تبدو اليابان أقلّ حركة؛ إذ طورت نظام QZSS كبديل يدعم GPS داخل المدن العمودية بكثافة مثل طوكيو، عبر أقمار في مدار شبه عمودي يضمن بقاء الإشارة متاحة حتى وسط ناطحات السحاب، مع خطط لتوسعته إلى 11 قمرًا، خلال العقد المقبل.
في الوقت نفسه طرحت كوريا الجنوبية مشروع KPS الذي يستهدف إطلاق 8 أقمار صناعية بحلول 2035 لخلق منظومة وطنية مستقلة تدعم الاقتصاد والدفاع والملاحة داخل شبه الجزيرة. كل هذه الخطوات تُرسم في سياق رغبة متعاظمة في حرية اختيار التقنية دون تبعية.
لكن أساليب الملاحة الأرضية لا تتوقف عند حدود الأقمار الصناعية، فالمؤسسات البحثية والشركات الخاصة بدأت تكشف عن رؤى غريبة وجريئة، وطورت شركة SandboxAQ، الناشئة التي نشأت من أبحاث جوجل، تقنية AQNav، التي تعبر عن الملاحة اعتماداً على قراءة المجال المغناطيسي للأرض باستخدام أجهزة كمومية مع الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها مقاومة للتشويش والتزييف.
ولطالما اعتبر الحقل المغناطيسي جزءًا من بنية الأرض الثابتة، وهو ما يعطي التقنية استقلالًا منقطع النظير.
كما ظهرت تقنية eLoran، وهي نظام ملاحة أرضي يعتمد على أبراج طويلة المدى يبثّ إشارات تشبه GPS، قادر على تقديم دقة تصل إلى نحو 8 أمتار، صُمم للوقوف كشبكة احتياطية لو تعطّل GNSS، وجربت كوريا الجنوبية هذه التقنية لتكملة أنظمة الأقمار، خصوصًا في مواجهة محاولات التشويش الميداني.
وهكذا، يبدأ العالم في كتابة فصل جديد لا يتناول من يملك النظام الأقوى، وإنما من يعيد تعريف المفهوم ذاته، خارج سيطرة الأقمار فقط، نحو فضاء يجمع بين الأرض والكون في تناغم تقني واعد.